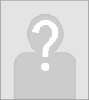ما أكثر المرات التي يزعم فيها القادة العرب أن عليهم أن يثبتوا للعالم أمرا ما! فقبل أيام قبلوا الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ليثبتوا للعالم – بزعمهم - أنهم "مع السلام" و لكي لا يدعوا للخصم حجة. زعموا ذلك أيضا عندما قبلوا بالمفاوضات الغير مباشرة مع إسرائيل و قالوا حينها إنها – أي المفاوضات - ستكون لمدة أربعة أشهر و لن تستحيل إلى مفاوضات مباشرة ما لم يتوقف الاستيطان و تثبت إسرائيل أنها جادة في السلام.
مثل ذلك قيل سنة 2002 عندما قدموا مبادرة السلام العربية، و مثله أيضا سيقال في المستقبل لدى تقديمهم مبادرة جديدة في هذا المسار أو تغطيتهم على تنازل جديد. فلماذا – إذن – هذا العذر؟
للجواب علي هذا السؤال عدة جوانب أحدها أن هذا العذر يخفي – أو هكذا يتصورون – عن شعوبهم حقيقة أن قراراتهم كانت استجابة لضغوط مورست عليهم، فيحفظون حينئذ ماء و جوههم و يدفعون عن أنفسهم تهمة الخنوع و تضييع الحقوق. و لعل قارئ هذه السطور يدرك مدى سخف هذا الخداع و كونه لا يكاد ينطلي على أحد ما عدا أصحابه.
من جانب آخر يأتي هذا العذر كمثال على لغة خاصة لا تستعملها أمة إلا في مرحلة معينة من تاريخها. و لأن العجز و الخنوع هما عنوان هذا المرحلة الراهنة من تاريخنا فإن لغتها تحوي أمثال هذه الأعذار و المسوغات التي ما كانت لتكون لو أننا كنا في عزة من أمرنا و منعة. و لا نحتاج لأن نسهب في أمر هذا العجز و ذلك الخنوع، فهذا موضوع قد أشبعه الكتاب بحثأ و تقليبا، قديما و حديثا.
علي أن الجانب الأكثر إثارة – لكاتب هذه السطور على الأقل – يكمن في أن هذا المبرر يشي بوجه من الوجوه بكيفية تصور هذه القيادات للعالم ( و الغرب خاصة) من حولها و علاقتها به. يفترض هذا التصور أساسا أن لدى العالم مجموعة من الانطباعات السيئة عنا نحن العرب و المسلمين: كالانطباع بأننا متطرفون و غير مرنين في معاملاتنا و عنيفون في سلوكنا و متخلفون و غير واقعيين و عاجزون عن مجاراة الواقع و انتهاز الفرص و غيرها، و أنه متى ما عالجنا هذه الانطباعات و تخلصنا من آثارها فإن العالم سيقف معنا و نحن ندافع عن قضايانا و سيناصرنا في استعادة حقوقنا، و هذا بدوره سيساعدنا في حل العويص من مشاكلنا.
لا يقتصر هذا التصور على القادة و السياسيين و من في ركابهم من كتاب و صحفيين بل يتعدى هؤلاء إلى بعض المفكرين و الأدباء و الدعاة؛ إذ تعتقد هذه الفئة أن هذه الانطباعات – حقيقة كانت أم افتراءا - يمكن تغييرها بمواقف – كهذه - واقعية و عملية وغير حماسية أو انشائية، كما تصفها في أدبياتها، فالسياسة عندها "فن الممكن".
مكمن الخطأ في هذا التصور عدة أمور:
أولا: أنه يتناسى أن هذه الانطباعات لم تأت من فراغ و ليست سواءا، فمنها ما له سياق تاريخي كالصراع بين الشرق و الغرب و الحملات الصليبية و الفترة الاستعمارية؛ و منها ما له مبرراته في عبثية سياساتنا و فظاعة تصرفات البعض منا وسوء أوضاعنا الراهنة؛ و منها ما يأتي في سياق صراع المصالح بيننا و بينهم.
ثانيا: أن هذا تصور غير واقعي للعالم من حولنا. فالعالم ما زال – كما كان دائما - تحركه المصالح. و ما زالت مصالح الأقوياء مقدمة علي مصالح الضعفاء، فإذا تم لأمة من الأمم تحقيق مصالحها و لو كان في ذلك من ضرر الآخرين و أذاهم الكثير، فلن تتورع عن ذلك.
ثالثا: أن الحقوق لا يستعيدها إلا أصحابها المطالبون بها. و أن الآخرين و إن تعاطفوا معنا و ناصرونا و ساندوا قضايانا، فأن هذا السند و تلك المناصرة لا تعدو أن تكون معنوية تساعد على النصر و لكنها لا تصنعه.
و لو أنهم فكروا مليا لما وجدوا خطة أنجع في تصحيح هذه الانطباعات من أن تكون لدينا علاقة صحية مع هذا العالم. هذه العلاقة الصحية لا تكون إلا بالاحترام المتبادل و المعاملة بالمثل. أما علاقة التابع و المتبوع و العصا و الجزرة و الضعيف و القوي و المتقدم و المتخلف فهي كلها علاقات مرضية تزيد من مثل هذه الانطباعات و لا تنقصها.
إننا لا ندين لهذا العالم بشيئ حتى نثبت له شيئا، و مهما صنعنا فلن نكسب احترامه ما دامت هذه حالنا و تلك مواقفنا. فالعالم لا يكن احتراما للضعفاء لاسيما أمثالنا الذين هم في كثرة من العدد و وفرة من المال، إذ ما يقعد بمن توافرت له أسباب القوة عنها إلا ضعف الهمة و خور العزيمة و غياب الطموح، و هذه أمور لا تجلب لأصحابها إلا الازدراء و قلة الاحترام. و إننا و هذه حالنا و تلك مواقفنا لنأتي – و يا للمفارقة – من الأمور ما ندعي الفرار منه و نقع في عين ما نحتاط من الوقوع فيه. و هل نحن اليوم أحسن حالا من إخوان لنا – إبان زحف التتار -كانوا ينتظرون الجندي التتري ليذهب فيحضر مديته و يجتز رؤوسهم، أو من أولئك الهنود الذين خاطبهم غاندي ذات يوم قائلا: لو كنتم ذبابا يطن في أذن الانجليز لخرقتم آذانهم. و هل يستحق الاحترام قوم يعتقدون أن 99% من حلول مشاكلهم بيد غيرهم.
و لعل الأحرى بهؤلاء القادة إن أرادوا إثبات شيئ أن يثبتوه لنا نحن – رعاياهم و شعوبهم. فليثبتوا لنا أنهم ليسوا طائفيين و لا عنصريين و لا دعاة فتنة، فتختفي هذا الآفات من بلداننا؛ و لتتسع صدورهم لمُواليهم و مُعارضيهم، فتسعنا جميعا أوطاننا؛ و ليثبتوا لنا أنهم مصلحون و ليحاربوا الفساد في أنفسهم و مجتمعاتهم، فيصلح حالنا؛ و ليثبتوا لنا أنهم أحرار ديمقراطيون يدافعون عن حرية شعوبهم و يُحَكموها في أنفسهم و سلطانهم، فنعز بهم و يعزوا بنا؛ و ليرونا من أنفسهم غيرة و أنفة ألا يضيع لها حق و لا تصاب لها كرامة و لا يهان لها كبرياء. ليفعلوا ذلك و أنا كفيل لهم بأن ينظر إليهم العالم بقدر عظيم من الاحترام و المهابة يعادل أضعاف ما يلقونه اليوم من الازدراء و الاستخفاف.
 طقس جاف شديدة البرودة على هذه المحافظات خلال الساعات القادمة
طقس جاف شديدة البرودة على هذه المحافظات خلال الساعات القادمة
 ضربة قوية تهز الهلال.. 6 نجوم على أعتاب الرحيل
ضربة قوية تهز الهلال.. 6 نجوم على أعتاب الرحيل
 اسقاط مقاتلة أمريكية فوق البحر الأحمر.. والجيش الأمريكي يعلق
اسقاط مقاتلة أمريكية فوق البحر الأحمر.. والجيش الأمريكي يعلق
 جيش السودان يسيطر على أكبر قاعدة عسكرية
جيش السودان يسيطر على أكبر قاعدة عسكرية
 8 قيادات بارزة ضمن قائمة بأهداف إسرائيلية في اليمن.. وقيادات حوثية تفر إلى صعدة
8 قيادات بارزة ضمن قائمة بأهداف إسرائيلية في اليمن.. وقيادات حوثية تفر إلى صعدة
 فتح كافة المنافذ الحدودية بين السعودية واليمن
فتح كافة المنافذ الحدودية بين السعودية واليمن
 هكذا تعمق المليشيات معاناة المرضى بمستشفى الثورة بصنعاء
هكذا تعمق المليشيات معاناة المرضى بمستشفى الثورة بصنعاء
 القائد أحمد الشرع : أعدنا المشروع الإيراني 40 سنة إلى الوراء
القائد أحمد الشرع : أعدنا المشروع الإيراني 40 سنة إلى الوراء
 طهران تعلن مقتل أحد موظفي سفارتها في دمشق
طهران تعلن مقتل أحد موظفي سفارتها في دمشق



 طباعة الصفحة
طباعة الصفحة كتابات
كتابات