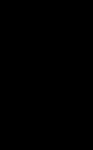قرار مفاجئ بإغلاق باب الحوار اتخذته السلطة وأعلنت عنه على لسان صادق أمين أبو راس أبرز ممثليها في الحوار الوطني، والمؤشرات تقول إن السلطة لم تغلق الباب بالمفتاح، بل كأنها تنوي العودة في وقت قريب، ويبدو أن الأمر ليس إلا لعبا على عامل الوقت ونوعا من التأزيم للضغط على المشترك ليقبل مستقبلا بما لم يقبل به سابقاً.
وفي أي لحظة سيخرج الرئيس عن صمته ليدعو الأحزاب مجددا لاستئناف الحوار بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام، ذلك أن أحزاب المشترك -وعلى امتداد فترة الحوار الذي انتهى قبل أن يبدأ- لم تعترف لرئيس الجمهورية بصفة «الراعي» للحوار، وبعد أن يدعو الرئيس للحوار مجددا فإنه سيكون بذلك مستحقا بصفة رسمية لهذا اللقب. وسيرسخ من هذا التصور -في حال حدوثه- الانزعاج الذي قد يبديه الأخ الرئيس من الفريق الممثل للسلطة في ذلك الحوار، ولا يستبعد أن يصحب ذلك تغيير عدد من أبرز ممثليه في الحوار، خاصة وأن الأحزاب أبدت امتعاضا إذ لم ترشح السلطة من يمثلها من شخصيات الصف الأول كما عبر عن ذلك صراحة في حوارات مع الأهالي قبل أكثر من شهر كل من الدكتور محمد السعدي -الأمين العام المساعد للإصلاح، والدكتور صالح سميع -أحد أعضاء لجنة المائتين (عن المشترك وحلفائه).
وربما أن عودة عملية الحوار إلى مجراها بناء على التدخل المتوقع من رئيس الجمهورية، هي ما يشير إليها الدكتور ياسين سعيد نعمان حين وصف قرار المؤتمر الذي أعلنه أبو راس بأنه موقف «أحمق»، ولم يفقد الأمل -بذات الوقت- من «أن تنتهي هذه الحماقة».
أيا يكن، هناك مؤشرات واضحة جلية عن عدم جدية النظام في الحوار، ويخطئ من يعتقد أن النظام سيقبل المضي معه في أي حوار وطني عن قناعة، ذلك أن الحوار الوطني الذي سيجري ضمن عدة خطوات آخرها عقد مؤتمر وطني، سيفضي إلى نتائج وقرارات ملزمة بشأن الإصلاح السياسي، وهذه القرارات سيتولى الإشراف على تنفيذها نخبة اتفق عليهم المؤتمرون، وعند ذلك: إما أن يرفض النظام هذه القرارات ويتملص منها، وبالتالي فكأن شيئا من الحوار لم يكن، وإما أن يقبل بها ويكون ذلك بمثابة تسليم طوعي للسلطة إلى هذه النخبة التي تمثل مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما يستحيل على النظام القبول به.
الحوثي يخرج من الحوار إلى الأبد
الحوثي من جانبه، يعد طرفا في الأزمة الوطنية وطرفا في الحل، وكان بالإمكان دخوله في حوار وطني في الفترات السابقة للحرب السادسة، أما اليوم فالأمر مختلف جدا، إذ الإصلاح السياسي الذي ينشده دعاة الحوار الوطني سيفضي -في حال تم وفي حال نجح- إلى سلب الحوثي سلطته التي عززها في المديريات الواقعة -حاليا- تحت سيطرته، وسيقضي على حلمه بالدولة المنشودة (لا أدري هل ما زال حلم الحوثي بالدولة المنشودة محصورا في شمال الشمال، أم قد توسع ليشمل شمال اليمن)!؟
وإضافة إلى ما كسب في الحرب السادسة، فإن الوساطة القطرية الحالية قد تمنحه وضعا جديدا، أو بالأحرى تعزز موقفه بشكل كبير. وإلى هذا وذاك، فإن التحركات النشطة التي يقوم بها الشيخ العكيمي في الجوف ستوسع خارطة المعارضة هناك -بحسب ما أشار إليه أحد مشائخ المشرق في حديث خاص. ذلك أن التشتت الذي تشعر به قبيلة بكيل الكبيرة والمترامية الأطراف سيسهل عليه -أي العكيمي- تجميع أكبر قدر من بطونها تحت رايته، وسيكون -بالطبع- شوكة جديدة في حلق السلطة، إضافة إلى شوكة الحوثي، وخارطة الجوف ذات الحدود الكبيرة مع المملكة ستمكنه من لعب دور محوري يتجاوز المستوى المحلي. والغريب أن رموز بكيل الذين يتبوؤون اليوم مناصب عليا ويعتمد عليهم النظام في الوقت الحالي ويعقد عليهم الآمال في لعب أدوار لخدمته في المستقبل، لم يظهر أي منهم في صورة القائد الذي تقتنع به بطون بكيل وأفخاذها فضلا عن رؤوسها وفضلا عن أن يظهر مؤثرا -بأي قدر وأي مستوى- في المناطق الواقعة خارج إطار هذه القبيلة. وإذا كان هذا العجز ظاهرا للعيان وجليا في الوقت الحالي، فإن العجز في المستقبل وفي ظل الظروف الأصعب سيكون -ولا شك- هو القائم من باب أولى!!
وحاصل هذه الفقرة بعد الاستطرادة في الأسطر السابقة: أن الحوثي خرج من حكاية الحوار الوطني إلى الأبد. والحراك الجنوبي يعيش اليوم واقعا كالذي كان الحوثي يعيشه قبل نحو سنتين، وإذا استمرت الأمور بالسير في ذات الاتجاه، فإنه الحراك قد يكون بعد فترة -تطول أو تقصر- خارج إطار الحكاية، حكاية الحوار الوطني.
النظام والمشترك.. اتجاه إجباري
إذن، وبناء على ما سبق، على المشترك العودة السريعة إلى لجنته التحضيرية للحوار الوطني وتفعيلها، مع تنفيذ جملة من الإجراءات التي من شأنها نقل فكرة ونشاط اللجنة من الصالات المغلقة إلى الميادين المفتوحة وإزالة الآثار السلبية التي تشكلت لدى الرأي العام عن هذه اللجنة عبرت عنها وأوجزتها استقالات عدد من الأعضاء وانتقادات وملاحظات طرحت في الفترة السابقة من قبل أشخاص وأطراف شتى، مع اليأس من حوار وطني يدخله النظام في الوقت الحالي، إذ لا يمكن النظام أن يسلم الحكم لأي طرف، أيا كان هذا الطرف ولو كان ذا قربى. وهنا نجد أنفسنا أمام أمرين متناقضين: لا يمكن للنظام الدخول في حوار وطني، ولا يمكن إقامة حوار وطني من غير مشاركة النظام.
ويكمن الحل والتوفيق بين هذين النقيضين في مُضي المشترك ومن معه من القوى والأشخاص جادا في الحوار الوطني بدون النظام، وعندما تلوح أمام النظام بوادر النهاية ويرى كثيرا من المحسوبين عليه قد غادروا مربعاتهم في السلطة وانخرطوا في الحوار الوطني طمعا في ترتيب أوضاعهم المستقبلية، فساعتها سيهرع للانضمام مكرها، ولن يقف أحد أمام طلبه للانضمام، بل سيساعد ذلك على إنجاح عملية الحوار، وقد سبق أن كتبت بعد إعلان المشترك عن توجهه نحو الحوار تحت عنوان «الرئيس آخر من ينضم للحوار الوطني»، وفي هذا العنوان ما يغني عن اقتباس شيء من سطوره، وهذا بالرغم من الرفض الذي أبداه النظام يومها لذاك الحوار الذي دعت إليه أحزاب المشترك. ثم استمرت أحزاب المشترك في مشروعها ولم يلبث الرئيس طويلا حتى دعا -من جانبه- لحوار وطني تحت قبة مجلس الشورى، لكن الأحزاب رفضت هذه الدعوة وواصلت السير في مشروعها، ليعلن الرئيس -في مرحلة ثانية- دعوته لحوار وطني متنازلا عن شرط إشراف مجلس الشورى على الحوار. وإذن: ما هي المرحلة الثالثة التي سيضطر إليها النظام إذا واصل المشترك مشروعه!؟
ما أريد الخلوص إليه هو أن عملية الحوار التي ينشدها المشترك يجب أن تكون مطلبا شعبيا تفرضه الجماهير وتسند مقرراته وقراراته من الداخل، وتلوي مع ذلك سياسة الخارج إزاء اليمن وتقوم بتطويعها في السياق الذي يخدم عملية التغيير.
وإن نقل الحوار إلى الميدان يقتضي من قيادات الأحزاب «صاحبة المشروع الوطني الديمقراطي والمحرك الأول للشارع» التصدر للموقف وعدم التواري خلف آخرين أيا كانت المبررات والمسوغات، إذ لا مجال لتنفيذ الأمر على مراحل، أو بالأحرى قد انقضت المراحل الأولى وحان وقت المرحلة الأخيرة.
الأحزاب وكلفة الخروج للشارع
هنا تفكر الأحزاب بالكلفة، والكلفة -بالطبع باهظة- ولكن: عندما تحدد هذه الكلفة قياسا إلى الهدف المرجو ستبدو زهيدة مهما كانت كبيرة.
وأثناء الحديث عن الكلفة، لا يمكن لأي طرف معارض أن يحقق تقدما في أي اتجاه ما دام يحسب كلفته وخسائره المحتملة ولا يحسب الكلفة التي سيتحملها الخصم (النظام الحاكم)، ذلك أن كلفة الخصم ستكون أكبر ولا شك، وهذا سيدفعه إلى اتخاذ قرار إيجابي إزاء مساعي خصمه المعارض تضع حدا للتكاليف التي يتحملها.
لقد نزل القرآن الكريم بعد أول لقاء بين المسلمين وخصومهم من قريش بدرس بالغ الأهمية يلفت انتباه المسلمين إلى أن الاقتصار على حساب الكلفة التي يتحملونها دون النظر إلى الكلفة التي يتحملها الخصم، سبب جوهري من أسباب عدم تحقق النصر، وذلك في قوله تعالى «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله»، وورد في آية أخرى -والتكرار ليس عبثا- «إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون».
وكم استعظمتُ القائد العسكري الروسي «قسطنطين سيمونوف» عندما وقع على هذا المعنى الرفيع بالغ الأهمية وعبر عنه في كتابه الروائي «الأحياء والأموات» الذي يروي فيه أجزاءً من الحرب التي خاضها الجيش الروسي ضد النازيين في الحرب العالمية الثانية، وفي سياق الحديث عن أسباب الهزائم التي لحقت بالجيش الروسي والتراجع المستمر له أمام الآلة الهتلرية يقول إن الروس كانوا ينظرون إلى حجم الخسائر التي يتكبدونها، ويتراجعون تحت وطأة أوجاعهم وتحت ضغط الكلفة الكبيرة التي يدفعونها في المقاومة، ولم يكونوا -في ذات الوقت وكما قال- يحسبون حسابا للكلفة التي يتكبدها الخصم ولم يكن يجول بخواطرهم أن لدى الطرف الآخر من الأوجاع مثل التي لديهم وربما أكثر.
وفي حكم الأولين «إنما النصر صبر ساعة»، وتلك هي الساعة الأخيرة من الأزمة عند اشتداد الكرب، بينما الساعة التي يعقد عليها أمل النصر والنجاح -في خيار نقل فكرة الحوار الوطني إلى الشارع- هي تلك الساعة الأولى. حيث أن عادة الأنظمة في مثل هذه المواقف إظهار ردة فعل عنيفة وقوية تستهدف أولى خطوات الحركة الجماهيرية حتى تقتلها في مهدها، وإذا قررت الأحزاب السير في هذا المسار فعليها قبل الإقدام أن تتهيأ جيدا لامتصاص ردة فعل السلطة الأولى والتركيز غاية التركيز على البعد الخارجي، فإذا نجحت في ذلك -وبأي كلفة- فقد انتهى الأمر لصالحها وإن لم ينته، وانقضى الأمر وإن لم ينقض.
عند كل أزمة وفي أي مكان، يكون العقلاء في كل الأطراف مطالبين بالقيام بدورهم المتمثل في التهدئة وإلجام الناس لجام الحكمة واستحضار المصلحة الوطنية التي تقتضي إخماد كل البؤر التي ينشأ منها التصعيد للأزمة، لكن الأزمة المعاشة والأوضاع التي آلت إليها البلاد اليوم تقتضي من العقلاء تحقيق هذه الصفة فيهم بالوقوف الجاد والحازم. فليست التهدئة هي سلوك العقلاء دائما وأبدا، ولا التصعيد سلوك غير العقلاء دائما وأبدا، وإنما التهدئة سلوك العقلاء عندما يترجح أن المصلحة كامنة في التهدئة، والتصعيد سلوكهم أيضا عندما يترجح أن التصعيد هو الحل، «ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى».
ويلجأ الكثير ممن يتربعون على مواقع القرار الحزبي إلى إلجام غيرهم بعبارة «السياسة فن الممكن»، وكأن هذا «الممكن» علم لدني. وإن تكن السياسة هي فعلا فن الممكن، فلماذا لا يُطرح خيار اللجوء للشعب والالتحام به للدراسة والتمحيص على احتمال أن يكون هو أفضل «الممكن»!؟
وإن الأحزاب اليوم كمن ضل في الصحراء ووجد نفسه أمام خيارين: إما أن يغامر بالموجود من طاقته والماء المخزون فيه ويضرب بقدمه هنا وهناك حتى يهلك أو يجد مخرجاً، وإما أن يلزم مكانا واحدا يقبع فيه لا يغادره مبررا ذلك بأنه «يحافظ على الموجود» ولا يريد المغامرة به، والنتيجة الماثلة أمامه أو الماثل أمامها -في هذه الحالة- هي: الهلاك المحقق.
وأسوأ مفردات الكلفة المحتملة هي خشية تعرض الصف لانشقاقات وتصدعات، وهذه -بالفعل- قضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الإقدام، وقد رأينا كيف أن أناسا كان يحسب لهم حساب في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي أسسها المشترك انقلبوا على المشترك فجأة بمجرد دخول المشترك والمؤتمر في الحوار وإشهار لجنة المائتين، وكيف أعلنوا انسحابهم -حينها- صراحة، وبصراحة قالوا: نحن في المؤتمر الشعبي العام فكيف نكون طرفا ضدا له في الحوار؟ وبناء على هذا يتوقع فقدان الكثير من الأنصار بصورة مستمرة كلما استمرت أزمة المواجهة السلمية في التصاعد، فهناك أشخاص كثيرون -بل وربما أطراف وقوى- يتوقون ليد تمتد إليهم من السلطة ليسارعوا إلى تقبيلها والتمسك والتمسح بها على حساب المشروع الوطني وعلى حساب الهدف المشترك.
وإن صح أن هذا الأمر واحد من موانع سير الأحزاب في اتجاه الحوار المسنود بحركة جماهيرية شعبية شاملة، فهل حُسب بالمقابل عدد الأفراد والأطراف التي ستنضم وستملأ مكان هؤلاء المنسحبين وستملأ -إضافة إلى ذلك- مساحات شاسعة؟
إن كثيرا من الذين انضموا للحوثي وهم الأغلبية من أنصاره على الأرجح، لم ينضموا إليه قناعة به، بل لأنهم لم يجدوا من يحمل لواء المعارضة المقنعة (بالنسبة لهم على الأقل)، كما إن التكتلات المناطقية والقبلية التي تتوالى وكل يوم يعلن عن تكتل جديد، إنما هي ترجمة لشعور لدى الناس حاصله إحساسهم بضرورة الاصطفاف الذي يكسبهم القوة في مواجهة الانهيار، وليس صحيحا أن الانهيار احتمال مستقبلي وارد، بل أصبح أمرا واقعا ومعاشا، وما يحدث اليوم هو بدايات حقيقية للانهيار. وإن يكن هناك محاولات مطلوبة لمنع الانهيار -كما نقول وكما نطالب دائماً- فإنما المقصود -فقط- منع توالي مراحل الانهيار. وخروج الأحزاب للشارع سيمثل -عند كل هؤلاء الباحثين عن التكتلات الواقية- الإطار الأكثر أمنا والأقدر على تحقيق رغبات النفوس المؤملة خيرا، وتأمين النفوس المترقبة شرا.
هذه التكتلات القبلية والمناطقية لو أنها وجدت في الميدان طرفا يتبنى التصحيح ويطالب بالإصلاح ويقوم بذلك عمليا على أرض الواقع بصيغة أبلغ من هذه التي عليها المشترك وحلفاؤه اليوم حاملا لواء المشروع الوطني لوطن ديمقراطي واحد، لانضمت إليه تباعا ولوجدت فيه نفسها.
وإن ما بعد الإقدام على هذه الخطوة التي أراها الخيار الأوحد أمام الأحزاب، هو وضع مجهول، والإنسان بطبعه يخشى المجهول ويفضل عليه الواقع المعلوم مهما كان مريرا. ذلك سلوك غريزي غير واع، أما السلوك الواعي فيقوم على أساس أن المجهول الذي يأتي بعد مغامرة التغيير التي اقتضاها وأوجبها الواقع، هو -كيفما كان- أفضل من المجهول القادم جراء الاستسلام لهذا الواقع. والخسائر المحتملة من المغامرة والخروج إلى الميدان ليست أعظم من الخسائر الناجمة عن عدم التحرك، مع فارق بسيط يتمثل في أن خسائر التحرك محتملة وليست أكيدة، وخسائر عدم التحرك محققة وليست محتملة.
لحظة تحدد مستقبل اليمن..
ربما يستساغ من الأحزاب ميلها إلى الانتظار وبذلها المحاولة المحدودة للإصلاح وإنقاذ البلاد.. ربما يستساغ منها هذا لو أنها تتلقف ما يتساقط هنا وهناك من النظام الذي يتعرض للمراحل الأولى من الانهيار. أما والحال هذي الحال، فإن ما يتساقط تتنازعه مشاريع صغيرة. وكلما انحسر النظام وانحسرت سلطته، انحسرت هي -أي هذه الأحزاب- وانحسرت سلطتها. وكلما فقد النظام الأمل بأن يكون له دور في المستقبل، فقدت هي ذات القدر من الأمل بلعب دور في المستقبل. وما سيجري على النظام -في حال الانهيار- والوضع على ما هو عليه الآن، سيجري على الأحزاب بالتأكيد. وانهيار النظام -والحال هذي الحال- يعني انهيار الأحزاب معه. وإذا كانت الأحزاب محظوظة واستطاعت أن تلملم نفسها في ذلك الوقت، فلن ترث النظام كما تتصور. إن المستقبل لن يتحدد ذاك اليوم بصورة مفاجئة، بل المستقبل هو وليد اليوم.
وفي الأثر أن معاوية بن أبي سفيان قال لعمرو بن العاص (رضي الله عنهما): إني أراك في موقف فأقول أشجع الناس، ثم أراك في موقف فأقول أجبن الناس. فقال له عمرو: إذا رأيت الفرصة تواتيني كنت أشجع الناس، وإذا رأيت الفرصة تفوتوني كنت أجبن الناس. ذلك قول مأثور عن خبير الحرب والسياسة الذي طار صيته متجاوزا قبائل الجزيرة العربية حتى بلغ أدغال الحبشة وقصورها وقد كان صديقا مقربا للملك النجاشي وما زال شابا فتيا، وحديثه موجه إلى قادة الأحزاب، فهم وحدهم المسؤولون -بمساعدة مؤسسات أحزابهم- عن تقدير الفرصة الحالية وما إذا كانت تواتيهم أو تفوتهم، وهي الفرصة التي يتحدد -بناء عليها- شيء كثير من مستقبل البلد، ويتحدد -بناء عليها- ما ستقوله الأجيال القادمة عنهم وعن أحزابهم وما سيكتبه التاريخ فيهم كذا أو كذا..!!.
 رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة
رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة
 الريال اليمني يواصل الإنهيار نحو الهاوية أمام العملات الأجنبية اليوم
الريال اليمني يواصل الإنهيار نحو الهاوية أمام العملات الأجنبية اليوم
 صور بالأقمار الصناعية تكشف النشاط العسكري للحوثيين في مطار الحديدة
صور بالأقمار الصناعية تكشف النشاط العسكري للحوثيين في مطار الحديدة
 فيديو مروع .. عنصر متحوث يحرق نفسه امام تجمع للحوثيين وسط ميدان السبعين بصنعاء
فيديو مروع .. عنصر متحوث يحرق نفسه امام تجمع للحوثيين وسط ميدان السبعين بصنعاء
 الصحفي بن لزرق يشعل غضب الانفصاليين بتغريدة منصفة كشفت عظمة «مأرب» ويؤكد: اتحدى اكبر مسؤول في الدولة ان يكذب حرف واحد مما كتبته
الصحفي بن لزرق يشعل غضب الانفصاليين بتغريدة منصفة كشفت عظمة «مأرب» ويؤكد: اتحدى اكبر مسؤول في الدولة ان يكذب حرف واحد مما كتبته
 عقب اقتحامه للمنبر رفقة مسلحين.. خطيب حوثي يتعرض لإهانة موجعة من قبل المصلين
عقب اقتحامه للمنبر رفقة مسلحين.. خطيب حوثي يتعرض لإهانة موجعة من قبل المصلين
 تفاصيل صادمة.. قاتل صامت يختبئ في مشروب يومي يشربه الجميع
تفاصيل صادمة.. قاتل صامت يختبئ في مشروب يومي يشربه الجميع
 الباحث على سالم بن يحيى يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة المنصورة بمصر بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف
الباحث على سالم بن يحيى يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة المنصورة بمصر بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف
 وفاة برلماني يمني بصنعاءإثر ذبحة صدرية مفاجئة.
وفاة برلماني يمني بصنعاءإثر ذبحة صدرية مفاجئة.



 طباعة الصفحة
طباعة الصفحة كتابات
كتابات